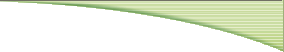حكايتي اسمها مريم
رحمة المغيزوي
(1)
في داخلي
كانت الحكاية كبيرة هذه المرة
أكبر من المخاض الذي عانته أمي وهي تضع طفلتها الأخيرة ،وأكبر حتى من حزنها ، عندما فتح أبي فرجة من الباب وقال باكيا دون خجل في وجه النساء الحاضرات حول أمي
- مريم ماتت ، من وين أجيب مريم غيرها ؟!
لقد انتظرنا ميلاد " مريم " أكثر من انتظارنا لأي شيء آخر نتمناه في الحياة ، أيقنا –نحن الصبية الخمسة – أن ميلاد طفلة بعدنا سيكون بداية الخير الذي سيفتح لنا باب البركة الموصولة باسم فتاة يشبه اسم "مريم المباركة " ، كما تحملتْ أمي كل العذاب في حملها حبا في أبي الذي تعلق قلبه وفكره من أن ميلاد "مريم " سيكون إنذارا مفرحا لكل الخسائر التي مني بها في حياته السابقة ، علق على " مريم " كل أحداث حياته ، فعندما أخبرته أمي بحبلها ، نهض قائما ووضع يده على بطنها وقال :-
- هذي مريم . فلبي يخبرني أنها بنت .
كان يعد على أصابع يده الأشياء التي ستعود إليه بعد ميلاد "مريم " ، الإبل التي نفقت في عامها الماضي ، محصول التمر الذي مات وهو في بداية موسمه ، وفكر ذات مرة بصوت عالي معلنا عن أمنية – أصبحت واقعا فيما بعد
– راح أتزوج ويكون لي بنتين باسم مريم .
في أيام انتظارنا " مريم " بقي بقربنا ، أعادني في شهر أمي الأخير إلى " حوض الجز " ، وأكثر من الذهاب إلى البقعة المباركة ، أخبرنا في ليلة أنه سيفتخر بولادة "مريم " الصغيرة بين الناس ، وسيصبح أبو الأولاد وأبو "مريم " ، من جانبها وعدتني أمي بيمين قاطع أني سأحمل مريم الصغيرة إلى البقعة المباركة وأنها وأبي وأخوتي سيسيرون خلفي وفاء بالنذر الذي قطعته لله إذا أنجبت فتاة بأن تغسلها من ماء وادي الجز . كان اسم "مريم " يتردد في أرجاء البيت حتى شعرنا بها تكلمنا من وراء حجبها ، وكانت أمي كلما مسحت على بطنها المكورة وخاطبت " مبارك" بيقينها عن ولادة " مريم " ، رد عليها بابتسامة ودود :
- ما كل مريم ،تشبه مريم .
- بنتي راح تشبه مريم "بنت جدنا عبدالله الحمر .
وتلك الحكاية كانت أكبر أيضا من السير الذي كان " مبارك " يمارسه كلما أحس نفسه يغرق قريبا من أحزانه ، فيمشي خطوات ، ثم يجلس على " العِرْق " ذاك المكان الفسيح المرتفع في قرانا ، وكأن التشابكات العديدة في نفسه لن تحل إلا عندما يمد قدميه إلى الأرض - التي لم تغزوها المباني- ،ويغرزها في رطوبة التراب ، فيشعر أنه يمد إلى رحم اليابسة العرق المزمن بالحزن وينتظر أن تمده بطاقة من حياة غير مرئية والتي تيقظ الإنسان الساكن فيه.
إنها حكاية أكبر مني ومن كل شخص جرب أن يهجر " حوض الجز " ثم قرر أن الأوان قد حان ليعود أليها بعد أن اكتشف أنه خالي الوفاض من أي شيء إلا من رغبة ملحة بأن لا شيء يستطيع أن يستر موته إلا الرمال التي بذر فيه أصله وأصل أجداده ، الذين شاهدهم كبارا وهم يتغنون بالشمس حين حرقت كل أحلامهم التي حملوها من سهر الليالي الساكنة ، الحكاية بذاتها معقدة إذ تبقى تذكرني كلما داستُ على بقاع " حوض الجز " بالموت ، الذي بقي مرتبطا هنا بكل شيء ، وفي كل اتجاه ، الحق الحتمي الذي لا يمكن أن يكون خفيفا ، ولن يمر كحدث صغير ومألوف ، إنه موت ثقيل ومقلق يكاد أن ينتزع مع كل جسد جمدت الروح فيه ، كل الحكايات والكلمات التي تنبت على الشفاه فيحيل القرية - التي باتت حدودها قريبة من الفناء في أرض المدن التي أخذت ترفع رأسها بالقرب منها - إلى بؤرة توجس من الفناء في الغرباء الذين كثيرا ما ابتعدوا عنهم ووضعوا بينهم وبين الالتصاق بهم حاجزا لم يتعدوه إلا لضرورة ملحة وفي أوقات اجتياح رغبة كبيرة وقاتلة لبعضهم .
ساورني الخوف من الموت وأنا أعود إلى "حوض الجز " ، كنت أشعر أن أمرا يتفاعل بتناقض كبير في داخلي ، مرات عديدة كانت صور المدينة تمر علي بإلحاح متواصل فأشعر بالحنين للضياع فيها ، حيث الوجوه لا تشبه أي وجه أعرفه في "حوض الجز " ، في المدن الكبيرة كل الأقدام تركض وراء لهث يومي شبه مكرر ،لا يمكنك من امتلاك القدرة على الوقوف لتقرأ ما يجول في الرؤوس ، كل يدافع ذاته ، يصبح جزيرة منفصلة عن الآخر ، دون أن يهتموا بمعرفة من أنت والى أين تسير ، يشعرني ذلك مؤقتا بالراحة ، أنا إنسان منفصل بشكل تام عن الناس الآخرين لي حدودي التي لا يقترب منها أحد ، الفاصل يشملني جسدا وروحا ، وهذا الذي افتقده "مبارك " تحديدا في "حوض الجز " ، كان يخبرني
- أريد أكون وحدي ، ليش أحس أن كل الناس في ها المكان يعيشون في راسي ويعرفون أفكاري ؟!.
نحن نسير وكأن الخطوات تنبت في داخلنا أولا ، فنقشعر بوخزها وبعدها نتحرك إلى وجهتنا ، جميع خطوات الناس هنا تعرف ، كيف تفكر؟ وأين تسير ؟ كنت أشعر أن ذلك منتهى الانتهاك الذهني ، تمتزج بفوج البشر هنا ، والكل يسألك
- على وين دربك ألحين ؟
ولأننا من عرق واحد ، لا أجرأ أن أفكر بأي فكرة تتصل بداخلي ، أخاف أن يكون الدم المشترك بيننا له قدرة خارقة على قراءة بعضه البعض ، أخاف أنا أسير بينهم ويرتفع صوت وهو يقول
- رحت بيت مريم ، وتفكر فيها وأنت تتوضأ حتى تروح إلى البقعة الطاهرة ؟ حرام عليك !
في وقتها سأعرف أني ضعت مرتين ،مرة عندما اشترى لي أبي ثوبا جديدا وأوصلني إلى المدرسة واضعا كتابا ملونا في يدي وقال لي
- أنت غير ، "حوض الجز " ما أرضك ، ما أريد تركض وراء الإبل ، أنت يدك بس حال الكتب .
و المرة الثانية كانت عندما رأيت مريم تسير بهدوء أمامي ، صدقت عندما كنت أقرب إليها من حبل الوريد كلام " مرشد "
- كل حرمة أسمها مريم راح نحبها حتى لو ما تسوى شيء .
قبل أسبوع من عودتي كانت وجه "مبارك " حاضرا ، حضوره اللافت أوقفني قبل أن يجرب الموت ويترك الصمت على التلال الفسيحة قال كلمة رددها الناس هنا بعدما خفت وطأة الموت
- حوض الجز تنادي أولادها لما يقرب موتهم ، تحس أنك تشم ريحة الوادي والتراب وأنك تشتاق حالها وايد .
سألتُ نفسي كل لحطة هل عدتُ وأنا أشتاق إلى هذه البقعة ؟، هل يسري الموت في أوصالي دون علم مسبق مني ؟ أما زال ظل " مبارك " موجودا ؟ ، وأنا أتبعه كما فعلت في صغري ، أما زال يراقبني من مكان بعيد كما كان يقول
- وين ما تسير عيني عليك ولو بعدت إلى آخر الدنيا .
كانت الأمور غير واضحة لي ، شيء في داخلي كان مبعثرا ، وغير مرتب بالطريقة الصحيحة التي كانت سابقا ، شيء لم أشعر به حتى في تجربة الموت التي يخافها أهل " حوض الجز " ، وتأكد هذا لي عندما مات " مبارك " شعرت لحظتها أني بدون أقدام ، ثقل الموت كله تركز على خطواتي ، كنت خائفا وغير موقن أنني أستطيع أن أدخل على بيت "مبارك " لأراه وهو جامد ، تعطل كل قدرتي على المشي ، اختبأت كطفل صغير وراء حائط غرفته . عندما عدت راكضا إلى البيت وصرخت في أمي
- مبارك مات .
خانها كل إحساس الدم الذي يربطها به ، ولم تستوعب أبدا من يكون "مبارك " الذي أتحدث عنه ، وعادت لتسألني
- من مبارك ، تكلم ؟
- أخوك مبارك مات .
احترمت رغبته دائما حتى عندما أصبح التراب يفصل بيننا ، قال لي دائما
- لا تناديني خالي ، ما بينا أكبر من أني أخو أمك وأنك ولد أختي .
كان إحساسي أن موت " مبارك " يعني فيا يعنيه موت الحكايات والقصص ، وكان يعني موت قصة "مريم " العاشقة له ، كما كان يعني أكثر أني أصبحتٌ بلا ظل أحتمي به من كل لهيب يحرقني ، أنا الآن رجل يعود إلى وطنه الأول دون مناعة من أي شيء ، إلا أن الصدمة الأكثر عنفا كانت عندما اكتشفتٌ أني لن أراه عند مرابض الإبل أو عند البقعة الطاهرة، شيء ما تلاشي وانتهى ، لم نعد نحلم بوجه طفلة صغيرة نطلق عليها اسم "مريم " في بيتنا ، ولم يعد "مبارك" يفاجئنا بزيارته ليكسر حاجز التخوف الذي بقي مركونا في نفوس أهل " حوض الجز " منذ زمن الصراع مع حبات الماء ، كما غابت عنا صورة "مريم " العاشقة المجنونة والتي وقفت بثيابها السوداء في حداد على الحبيب الذي مات في أرض مرتفعة عن أرض " حوض الجز ، وفتحت أبواب بيتها لسبعة أيام ، باكية وخائفة وجزعة في وجوه الناس طالبة منهم أن يقدموا لها واجب العزاء في الرجل الذي فتح أبواب الدنيا عليها وعلمها كيف تضحك ، وما عادت أمي تأتي على سيرتها قائلة :
- ماتت الحيا في قلوب الناس . وما عاد أحد يستحي .
كلما تذكرت أنها شاركتهم عزاء أخيها وهي التي لا تحمل دماء أهل " حوض الجز " ، وكانت تسخر منها في لحظات عابرة
- مريم ؟! اسم مريم عزيز عليها وعلى مثل شكلها
لازمتٌ بعد ذلك البيت لفترة لا أتكلم عن "مبارك " ولا عن وجه الذي تخيلته ل"مريم " العاشقة ، لا عن وجه الطفلة الصغيرة التي سهرنا وأخوتي نرسم لها ملامح وجهها ، إلى أن أعادني أبي إلى مدينة مريم .
الحكاية التي تعتمل في صدري تغشى وجه " مريم العاشقة " تنيره وتقف لحظة عنده ، ألمح طيفها كلما سلكت نفس الطريق ، تخبئ وجهها عني ، ثم أشم رائحتها تأتي من جهة بقعة "جدي الحمر " وهي تتغطى بجنح الليل. أتصور في نفسي أنها تنتظر ظلي لأكد لها أنا " مبارك " لم يمت وأني أحمل إليها منه هدية صغيرة ، عود ريحان ، أو قطعة حلوى أو كلمة ، أخشى أن توقفي وتقول لي كما قالت آخر مرة رأتها فيها
- خبر مبارك ، قول له " مريم " بعدها مريم القبلية ، ما تغير فيها شي.
عندما أسرع الخطى هاربا منها ، أسمع صمتها يتعانق مع المساء هنا صغيرا ومؤلما .
الحكاية التي احتفظت بها لا يمكن أن تكون إلا بحجم جدنا " عبدالله الحمر " ، وربما توازي في نظري حكاية ابنته "مريم " ، حكاية نوزعها نحن سكان " حوض الجز " بيننا كميراث عتيق نأبى أن نتركه حتى لو آلمنا وكان مصدر كوجع لا ينتهي ،وحتى لو جلسنا إلى بقعة جدنا " عبدالله الجمر " وبكينا بتذلل وانكسار ،وحتى ولو عدنا نجر بين أقدامنا كل السنوات التي كونت " حوض الجز " لنعلن كما أعلن " عمي حمدان " نبأ الفوز عن قطرات الماء
- من سنين الله الطويلة ، إحنا فزنا على الماي . من يومها ما شفنا راس أي وادي يطلع على هذي البقعة .
فيسكت كل من حضر وسمع وكأنهم يتذكرون من هم ، ماذا كانوا ؟ وكيف أصبحوا ، لقد آمنهم جدهم الأكبر من خوف الماء الذي كاد يقتلهم ، وأطعم بعد أن ذاقوا مرة الجوع والفاقة لزمن طويل ، وهم يتكلمون وفي الأثر الذي يرويه الأسلاف لمن هم أصغر منهم أن جدنا الأكبر " عبدالله الحمر " سار ذات يوم كثير المطر وخاض الوادي الذي علا هديره بينما وقف أهل القرية ينظرون إليه من مكان مرتفع إلى الوادي ،يؤد الكثيرون أن خروجه ذلك كان يشبه خروج المجاهدين في سبيل الحق ، كانت عصاه مرفوعة للأعلى كحد السيف وأنه كما قال لي أبي لي ذات مرة
- كان يسير مرفوع الراس وبين خطواته مسافة كبيرة .
من أعلى التل بان لهم طويلا ، جسيما ، كان يسرع بتصميم يشعل النار في قدميه ، وبانت حمرة وجه أكثر ،وغاب البياض الجميل الذي كان يشع حتى لحظات غضبه الكبير ، وحل محله حمرة قانية حتى صرخ فيهم من صرخ
- الحق هذا عبدالله الحمر .
وقف في وجه الوادي ، كانت ماء الوادي يعلو ، يقترب من جدهم الأكبر ،ثم يعود للانحسار ، يكبر الموج ثانية في وجهه ، ومن أعلى التل شاهدوه يخوض الوادي ، يصل الماء إلى وسطه يتسخ ثوبه الأبيض ، يغطي الماء المتساقط أمام عيونهم المنظر أمامهم يمسحون وجوههم يختلط الماء بالدموع ، كان جدهم الأكبر يغيب في الماء طويلا ثم يعود ملوحا بعصاه وهو يشير إليهم ويشعرون أنهم يفتقدون الرجولة ، وفي لحظة كان أمام أنظارهم وهو يعتلي جذع نخل جرفها الوادي ، يرفع عصاه ويظهر نور من وجه ونور من جسده يصبح جسده كتلة نور كبيرة ويسمعون صوته جهوري وواضح ينادي ابنته
- مريم ، مريم .
تركض "مريم " إلى الوادي ، تقف على الحد الذي يفصل الماء المتدفق عن اليابسة ، تمد يدها إلى أبيها ، تدخل إلى الوادي وحيدة دون سند من أحد الرجال الكثيرين الذين شهدوا الموقف ،تغيب عن أنظارهم ، يسمع صوت بكاء النساء ، بعدها يشع نور من المكان الذي غابت فيه يتعانق نورها مع نور والدها ، وفي لحظتها يقسم كل الأجداد الذين رؤوا ذلك أنهم سمعوا صراخ ماء الوادي ، صوت مخلوق مهزوم يموت بحرقة وغضب ، بعدها انحسر الماء عند البقعة التي غرس فيها جدنا " عبدالله الجمر " عصاه ودعاهم بيده إلى يشربوا الماء الذي أصبح صافيا عند قدميه ، ثم شاهدوه يختفي في بقعة ، هرعوا إليه دفعة واحدة
- يا ناس ، عبدالله الحمر ، جز رقبة الوادي . الوادي مات ، مات . شربته الأرض
عندما نزلوا إلى الوادي كان الماء لا يصل إلى ركبتين الرجل البالغ فيهم . انتهي انبعاث النور من الوادي ، وغاص في الوادي ، خف أنين كل شيء أمامهم ، بان لهم الجز في الأرض كبيرا وعميقا ، مدوا أيديهم وشربوا من الماء ، بكى بعضهم في وجه البعض ، كان عبدالله الحمر قد ضحى بنفسه وابنته ليفتديهم من الماء ، يومها شعروا أن لهم أرضا . وأنهم مجموعة من البشر لهم بقعة محمية من تقلبات الماء . وأن ولادة البنات ليست بالشر الذي توقعوه طوال حياتهم ، إذ وجود فتاه في كل البيت " تحمل صفات واسم "مريم" ابنة جدهم الأكبر نور لا بد منه في " وادي الجز" .
قبل ذلك كان شعورهم بالماء كبيرا حتى أنهم كانوا يشمون رائحته من مسافة بعيدة ، كانوا موقنين أن صوت الماء سيرغمهم ككل مرة على حمل أشيائهم الصغيرة والرحيل للبحث عن مكان لا يعرفهم فيه الماء ، وطوال تلك السنوات كان الماء يعرف مكانهم ، وفي كل مرة كان يغرقهم ويجبر من بقي منهم على البحث عن مكان لا يعرفه الماء ، وكأن الماء كان قدرهم ، شيء لم يستطيعوا فهمه رغم أنه يكون أليفا بهم أحيانا إلا أن خوفهم منه ظل قريبا منهم حتى إذا مد أحدهم يده إلى السماء وتحسس وجه السماء بقي الحاضرون بقربه منه متوجسين من النقاط الصغيرة التي تزداد حدتها في كل لحظة ، وهم وان نسوا كل شيء عن الماء فإنهم لا ينسون يوم الصريخ ،وعندما يتحدون عن ذلك اليوم يشعر من يستمع إليهم أن الصراخ سيبقى ينبعث في ذكرى ذلك اليوم ، حتى ولو قدر و اختفت "حوض الجز " ذات يوم .
في ذلك اليوم الذي فاجأهم به مساء قيظ ساخن ، كانوا نياما بعد أن انتصف الليل ،وفي الوقت الذي شعر فيه الكبار منهم بالماء ، ومن بعده شاهدوا أن قوة الريح تزيد ، رفعوا بنادقهم إلى السماء وأطلقوا عدة طلقات لخيفوا الشياطين التي تقود ذلك الهواء ، كان الصغار نياما في ليلتها لم يقدر أحد أن أمطار الصيف يمكن أن تحمل غدرا لهم إلا عندما وضعوا أيديهم تحت المطر المنهمر وصرخ أحدهم :-
- السيل يا جماعة ، الوادي سال يا جماعة .
في ليتلها داخلهم اليأس ،و شعروا بأن الماء سيذيبهم مع بيوت الطين ، وأن الريح ستقتلع كل شيء من مكانه ، وعندما تنامت إليهم أصوات الأطفال الذين فاجأهم الماء وهم نياما لم يجدوا إلا الصراخ المضاعف والتخبط بين الأزقة الضيقة وهو يحملون الأجساد الصغيرة كما لم يجدوا من يجيرهم إلا بيت جدهم " عبدالله الحمر " الذي وجدوه على سطح منزله رافعا يده إلى السماء بدعاء طويل وقد أصبحت عيناه بلون الشفق ، خافوا أكثر عندما رفعوا أيديهم إلى بالقرب من يده وكثرة الضوضاء ولم يهدئ الجميع إلا بعد أن قال جدهم الأكبر
- قولوا لا اله إلا الله . خلو اليتامى والمساكين ويرفعوا يدهم معنا .
بان الفجر وغمرهم النور . ارتفعت الأصوات بالعبارة الواحدة ، واختلطت ببعضها البعض ،كان داخلهم يغلي وهم يدفنون أبنائهم في الماء ، يحفرون الحفرة فيجدون الماء يملأها ، وعندما يقررون حفر حفرة أخرى لا تسعفهم الأرض التي ساروا عليها طويلا وأعطوها من تعب أجسادهم إلا أن تفتح لها قلبها عن حفرة ماء أكبر ، في لحظتها بكوا طويلا ،وعضوا على جرحهم بقسوة تعلموها من الماء الذي كانوا طريدته طوال عمر ذاكرتهم البعيدة . إلى استقروا في مكان التل وبنوا خمسة شواهد للقبور الصغيرة .
(2)
كانت تمطر
في العشية الثانية لي في "حوض الجز"
رغم ذلك كان ضوء الشمس ينير المكان بصفاء جميل يريح النظر ،وفي تلك اللحظة التي لم أستطع تسميتها إلى الآن مدت ثلاث راحات إلى السماء وبعد لحظة تكورت على تجمع حبات المطر المتساقطة بتؤدة وهدوء ، ولست أكيدا إن كنت قد رأيت هذا في الحلم أم أن يد جدي " عبدالله الحمر كانت ممدودة بعصاه الطويلة إلي ومن ورائها كانت نظرات عيونه تشبه عين الماء المنسابة تحته .
الغريب أن تلك الليلة كانت ساكنة جدا في " حوض الجز " حتى أن الكلاب التي ألفتها منذ أسبوع قضيته هنا قد تخلت عن عادة النباح المستمر وانزوت بعواء بعيد ، بقيت أتقلب على فراشي عدة مرات ، أضم وسادتي بين يدي ثم أعود بها وأضعها على رأسي مرة أخرى .
تجرأت وخرجت للحمامات البعيدة المقامة خلف الدار في نظام الدور القديمة في هنا عملا بوصية لجدي "الحمر" ولا يسع أي شخص أن يخالفها .
انثالت الصور والوجوه ، كانت صورة مريم كبيرة وابتسامة ودود ، تصورت أن القمر ينبت في جبينها وأنها تسير في فضائي المؤرق خطوة وتقف خطوة أخرى . ثم رأتها تختلط بصورة "مريم العاشقة " وصورة أمي وصورة أختي .
في اللحظة التي شعرت فيها أن المطر يتفجر من كل مكان ، غمر بقعة الأرض سكون مفاجئ وثقيل وأتاني صوت من بعيد ينادي وهو يلهث
- يا ناس ، ويا جماعة ، عبدالله الحمر طلع ، طلع عند راس الوادي الكبير .
التفت إلى جدتي التي كانت قد بدأت تشرب ما تجمع في يدها من الماء الطهور وقالت
- ما قلت لك أن جدنا "عبدالله الحمر " ، ما يموت أبدا .
استغرقني الأشياء تماما ووقفت لزمن لا أعرفه عاجزا عن الحراك ، فمن يعرفون" حوض الجز " هنا يعرفون فيه بقعة وقف عليها جدي " عبدالله الحمر " وأطلقوا عليها من بعده " البقعة الطاهرة " ويصر البعض على تسميته " حوض مريم " .
أبي الذي يروى هذا الخبر لي يقول أن "عبدالله الحمر " ليس جدي وإنما هو جدي وجد أبي وجد القرية بأكملها وهو الأصل الذي لولاه ما قامت حارة " حوض الجز ولا عرفنا كألف رأس من البشر باسم قبيلة بعينها ، تنتسب من جبل إلى آخر إلى جدها " الحمر " وتقسم برأسه وتقدم الهدايا له وتتطلب بركته في أمور حياتها .
في تلك اللحظة الغائمة أنزلت المرأة الواقفة على عل يميني كفها الممتلئة بالمطر وسقتني شعرت لحطتها أن في يدها نبع ماء لا يمكنني أن أشبع منه بينما يدها الأخرى تمسح على رأسي كطفل تدعوه بحنان إلى النوم .
في صباح تلك الليلة كان مذاق الماء ما يزال حلوا في حلقي ، وعندما تناولت فنجان القهوة من يد أمي قالت
- خير أن شاء خير ، جدك عبدالله الحمر ، ما يكون من وراه إلا الخير والبركة .
وعندما رشفت الثمالة كانت صامتة تفكر في مكان بعيد
- خذ الحلوى وماي الورد وسير لجدك .والله وحده بيسرها .
وعندما أخبرتها عن المرأة التي سقتني الماء ، قالت بوجه مشرق
- ذيك مريم ، ما أحد غير مريم .
في المساء تستيقظ " حوض الجز " كطفلة فرحة بالهدايا التي قدمت لها في أيام العيد ، تصبح عبقة وجميلة ، تتنفس من جوف الوادي الساكن بجورها ، تولد لدى السائر إلى بقعة جدي "عبدالله الحمر " أنها ما تزال تحتفظ بروح كبيرة في داخلها وأن لها أسرار لم تبح بها ، تلك القرية التي يزيد عمرها عن المائتين عام والتي بنيت بيوتها من الطين في أول إنشائها ثم أعيد ترتيبها من الحجارة الصلبة وكل بيت فيها يلتف حول البيوت الأخرى ليصل في النهاية إلى تكوين محيط دائرة حول البقعة التي صعد فيها "عبدالله الحمر " إلى منزله العالي الذي ظل مجهولا المكان من أهل القرية ، والأرض كما وصفت بأنها أرض مباركة لا يزرع فيها أي حب إلا أتى مضاعفا في ثمره كما أن قطعان الماعز والإبل قد تضاعفت منذ جز جدي " عبدالله الحمر " الماء وأبان له شقا غي وجه الأرض . لم يصب الإنسان نكبة فيها إلا ما كان من صنع يده .
(3)
في البداية وضعتُ الحلوى بجانب البقعة المطهرة ورششتٌ الحجارة بماء الورد الذي كان في يدي ، حاولت أن أتذكر ما يقوله أهل " حوض الجز " في مثل هذا الموقف ، وفي مثل تلك الحضرة ، وكيف أوصل إلي جدي ما في قلبي ؟، ولكني حاولت ، سأخبره أن حكايتي مع الزمان أسمها مريم ، وأنا طفل وأنا يافع ، وأنا متشرد في المدينة أو مختبئا في غرفتي في " حوض الجز " ، كل الحكايات كانت مريم . "مريم " التي دفنتها ، "مريم " التي بحث عن وجهها في غور الوادي ، حتى لحظات جنوني المحدودة كنت استمدها من صورة مريم المجنونة ، ومن ورائها " مريم " التي أشتكي منها ، مريم الحكاية الكبيرة التي سكنتني مؤخرا ، فأحسست أن الدنيا كلها تدور حول النساء ،"مريم التي اتحدت معها في لحظة ضعف فنسيت معها كل كلام العيب الذي لقنته أمي لي ، تذكرت هي دموعها فبكت ، عندها تركت الأرض التي أخذني أبي إليها يافعا وعدت أحمل أشيائي الصغيرة لأنام في "حوض الجز " متأملا في رؤية جدي الأكبر ، فيكون النبأ العظيم ، البشارة برؤية النبع من يدي " مريم المباركة " ، فأنا لم أترك المدينة وصورة مريم إلا لأكون في حضرة جدي العظيم " عبدالله الحمر " ولم أنتظر أسبوعا لأرى تلك الرؤية وأعلم يقينا أنه يناديني لأقف أمام بقعته الطاهرة ليسمع شكواي المطولة ،، وربما أعود من هنا بقبس ينهي الغصة التي تجرعتها لسنة
" مرشد" الذي أصبح يسير واثقا من خطواته قال لي ناصحا
- قول اللي في قلبك بصراحة ،وارتاح ، جدك عبدالله ما يحتاج يسمع كلامك لأنه يعرف اللي في قلبك
في قلبي قلت :-
" جدي عبدالله الحمر ، لقد جئنا من صلبك وأنت الأقرب الذي يستطيع فهمنا ، عندما ضاقت بي الأرض لم أجد إلا أرضك ،وعندما انكشفت سمائي عن فراغ كبير بحث عن شخص يستطيع فهمي ،فلم أجد إلا بقعتك أوي إليها ، أنت الذي زرعت هذه الأرض خيرا ومحبة ،وسيرتنا كبشر لهم كيان .
في عامي هذا، أنا أدعوك فقط ، بدعاء "مرشد" الذي جلس إليك شاكيا عن ألم قلبه وشتاته وراء امرأة وقال لك على مدار عام كثر فيه بكائه وكاد جسده أن يفنى في كل مرة وقف فيها مستغيثا بك ، أن تبدله حبا غير حبها ، وترشده كما أرشدك صوت الوادي في ليلة شجاعتك إلى سعادة القلب الحقيقية ،وفي ليلة رضاك عنه قال " مرشد " أن نفسه غادرت روحه ووجدها ذات صباح تستبدل حب النساء بحبك وحب الله .
أطلب أن تكون لي نفس كبيرة كنفس " مريم المجنونة " عندما تركت زوجا أرغموها عليه وعادت تبكي دون أن تخشى أي إنسان .
جدي الكبير لك وحدك أقرا وبكل ألم وأنا أصل إلى سن الثلاثين أن جميع القرارات السابقة التي اتخذتها في حياتي كانت قريبة من هاوية الخطأ أو هي الخطأ بذاته ، جدي أنا أطلبك بمعزة أبنتك "مريم " في قلبك ، فقد قال الناس هنا أن البيت الذي لا يوجد به بنت من بناتهم أسمها مريم فإنك لا تسمعه إليهم ، وأنا أعرف أنك أكبر من تفا هات البشر وعقولهم الضيق ، أنت تعلم دون أن ترانا كل ما نضمره في أنفسنا ،نعم اسم "مريم " لم يكبر في بيتنا كما في باقي البيوت ، نعم نسي أبي كل شيء ولم يتذكر إلا أن رحم أمي قليل البركة وأنه لن يحمل بركة اسم " مريم " ، فرحل دون أن نعرف ذنبه الذي كان سببا في أنه صرخ من كل كيانه بكلمة
- آه
لقد ماتت "مريم " ولم نحملها إلا إلى حفرة صغيرة ، كما مات " مبارك " ، أنت تعرفه ، كان لا يرتاح كما يقول لي إلا عندما يجلس إليك أو يجلس إلى النجوم ، وحدك تعرف لماذا عاش أعزبا مات وحيدا ؟ قال لي قبل موته قال لي
- يوم أموت اسأل جدنا الكبير عن سر موتي . وهو يعرفك ، يعرف أنك تساعدني وتساعد قلب " مريم " على الحياة من جديد .
وأنا لم أسألك ، كان يخبرني أنه يراك كثيرا في الحلم ويشرب من النبع الصافي من يد ابنتك "مريم " ،
- لقد أصبح من أهل الخير
كما قالت أمي في كل مرة حكى لها عن وجهك ويد ابنتك .
حكايتي كبيرة يا جدي ولن يفهمها غيرك ، لقد رأيت نورك وأنا أمامك الآن ، أنا أحب يا جدي ، ، قلبي الذي شرب من نبعك أصبح بعيدا ، بات يسهر دون أن يرى نجمك الذي قال مرشد أن نوره سطع عليه في كل ليلة كان ينام فيها بقرب أرضك ، أصبحت أبكي وأحدث نفسي طويلا بسبب حرقة في صدري ، صدق "مبارك " عندما أخبرني أن قلوبنا تبقى معلقة بخيوط لا نكشفها إلا عندما نقع في الحب عندما تسقط ولا يبقى إلا صورة من نحب .
في كلامك الكثيرة الذي بتناقله أهل القرية لم تقل لهم أن الحب حرام ، وفي السنوات القليلة التي عشتها ملأت الحياة من حولنا حبا ، أعرف أنك لن تردني خائبا أنا يا جدي أشكوها إليك ، أشكو إليك مريم ، تلك التي تعيش وأهلها في الأرض التي لم تباركت بخطاك ، ، هي – يا جدي – لم لا تحلم مثل كل "مريم " هنا ، هي تكبر بأفكار غريبة ، أصبحت تبتعد كلما رأتني ، أنت تعرف كل أحوالنا وان كان جسدك بعيدا عنا ، تعرف أن كل "مريم " هنا عندما تقف قريبة من قن الدجاجات وتراقبها وهي تحتضن بيضها لفترة زادت عن الثلاثة أسابيع ثم شاهدتها وهي ترعاهم وتغذيهم ،وتداعب ديكها صاحت بصوت امرأة سعيدة
- أريد أن أكون دجاجة .
الآن يا جدي وفي تلك البلاد البعيدة عنك ، تلك البلاد التي حذرت كل أبنائك من سكان " حوض الجز " منها ، وقلت لهم ، أن ماء من نوع آخر سيغرقهم فيها ، وجدت أن "مريم" تريد أن تطير وتحلق ، تنظر أحيانا إلي وتعلن أنها لا تريد أن يحتك جلدها بجلد رجل جرب التماس مع جلود الإبل ، أعد العروق يا جدي الأعظم إلى مكانك هذا ، كل عروقنا تحن إليك مهما ابتعدنا ، توصلنا بخيط القمر الذي يبقى مضيئا على بقعتك ، أنا لا أطلب أن تبدلني حبا غير حب مريم ، أبدا ، أريد أن أحبها حتى يضمني المكان الذي أخذ " مبارك " مني ، فأنا لم أملك حبا سوى حبها ، ولم أشعر بأني رجل إلا معها ، ولم أكتب لحياتي حكاية إلا عندما بدأت أعرف اسم " مريم " ، ولم أصبح إنسانا إلا عندما وضعت يدي في يدها ، واحتضنتها طويلا ، مريم التي اتقيت بها لأول مرة في المدينة كانت شهية ، بريئة حتى عندما واتتها الشجاعة واقتربت مني لتسأل عن أثر الوشم الصغير الذي يضعه أهالي " حوض الجز " على ساعد أبنائهم ، شممت منها رائحة الفرح ، الآن أنا ضعيف يا جدي ، ضعف مواسم المطر التي تمر بنا في سنوات القحط فقوني من عزيمتك ، ضعيف للحد الذي لا أستطيع فيه أن أظهر حبي حقيقة امرأة احتميت بصدرها ونمت براحة لأول مرة في حياتي ، أينا أخطأ يا جدي ؟ هي تريد أن تطير وأنا أريدها أن تشبه أرض " حوض الجز ، ، أنا لا أشبه " مبارك " أو أي شخص آخر في " حوض الجز " ، جبان لأقف في وجه لا أهلي وأخبرهم أن أسم " مريم " طيب حتى في البلاد البعيدة عنهم .
ها أنا عدت إليك لأنسلخ من جلدي الثاني وأنسلخ من عذاب اسم "مريم " ها أنا أرفع ماء حوضك إلى فمي عندما سمعت الناس يقولون أن من يشرب من هذا الحوض لن تسمع منه كلمة "آه " واحدة ، أتيت أستغيث بك ، فأغثني يا جدي ، أن في قلبي سكينة بأني لا أخون تعاليمك عندما أحب ،ولا أخرج عن بركتك عندما أقف صادقا معترفا بالحب الذي رسمته في وجوه الناس من أمد طويل ، جدي ،ببركة ابنتك الطاهرة اجعلني ................"
(4)
في المرة التي عدت فيها من " حوض الجز " ، اتصلت ب"مريم " لم أكن أحتاج إلى شخص ليسمعني بقدر ما كنت محتاج إلى شخص يشاطرني الصمت "ف"مريم " من الأشخاص الذين يشبهون المرايا تشعر في لحظات أنك تتحدث مع نفسك وترى كل ذلك التحول في قسماتك وروحك ، أمامها أستطيع أن أطمئن أنها تفهم ، خذلني قوتي ، لم أخبرها أن أبي أشاح بوجه عني ورفض الخوض أمرها برمته
و قال لي بصوت رجل منكسر ووحيد
- ارجع لأرضك أنا قلت لك " حوض الجز " ما بلادك أبدا .
كانت تضحك بمرارة وهي تمسح على تكوير بطنها أمامي قالت أنها تريد السير إلى جدنا الأكبر لتدعوه بأمر ، قامت و انتبذت مكان قصيا ، أشارت وهي تمثل الموقف ، سمعت صوتها تهمس بانكسار " جدي أسألك يكون أنجب فتاة ، وأنا أعدك أن أعود إلى أرضك ،وأن أسمي أول بناتي باسم ابنتك "مريم المباركة " ، ثم سكنت جاثية دون زيادة أخرى في كلامها .
في ذات صباح مبكر رأيت "مريم " تطير ، تحلق بعيدا عن السقف الغرفة ، تحدث فرجة في أديم السماء ، تفتحت أبواب كثيرة ، ترفع كلا يديها لتصل السحب البيضاء .
|