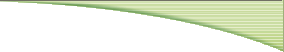حنين الأمكنة
رابية الهبوبية: لك يا منازلُ في القلوب منازلُ!
(1)
في منتصف الستينات – ليس على وجه الدقة - من القرن المنصرم انسابت قافلة صغيرة من رجال وركبان باتجاه البندر قيل أنها تهادت مع الغبش في يوم صيفي قائظ، وقيل أنها اخترقت زمهرير الصحارى، وقيل غير ذلك على أن المؤكد الذي سجله تاريخ تلك الرحلة المحلي هو هبتها على عجل، وتقاطرها خلف الكبير في المقدمة باتجاه الساحل إلى مسقط ربما ستكون تلك من أواخر القوافل التي تنجز مهمتها عبر الدواب قبل أن يحدث الفتح العظيم للطرق الترابية أمام رحلة المركبات المتسارعة النمو، والمتوالدة العدد في) لاندرو فر حمر) كما أخبرت الأغنية المحلية القديمة وغنى المغني، وطار بها الساري!
ثمة امرأة شابة في القافلة تحمل لفة رضيع ورد الدنيا قبيل أيام لم يكن عاديا - كما أنه لم يكن استثنائيًا كذلك – هبط إلى الدنيا بهدوء في غفلة عن الخلق كانت أمه تجلب الماء من شِرِيْعَة الفلج أعلى القرية - بعد أن أنجزت مهمة حش القت في النطالة الحدرية – حين أحست بحركات الصغير السريعة والمتتالية منذرة بالهبوط اختارت السير جنوبا باتجاه بيت جدتها لأمها حيث الهدوء الذي يلف المكان بصمته الدافئ المهيب، وماهي إلا لحظات حتى مزق الصغير بزعيقه وصراخه الصمت الذي لف المكان. كان بكائه الذي لم يتوقف ورفضه تلقف صدر أمه الحنون كما حرمت عليه المراضع من قبل كافيا لإحداث جلبة سائر ذلك اليوم في القرية الهادئة الصغيرة. استمر هذا الصراخ يعلو ويزداد حتى خيف على الصغير من آثاره فقيل لأهله: هل ندلكم على مكان يحفظه لكم، وكانوا لهم من الناصحين.
كانت أمه الشابة مثال العمل، والتفاني في تلك القرية النابتة فوق رابية مطلة على واد يتفجر في الأيام المطيرة وينساب من آمتها فلج رقراق. اشتعلت القرية – ذلك المساء - على حين غرة:
[- زوينه ربيت!
- مو تقولن تو شايفتنها تستقي م الفلج!
- والله قبل شويه شايفتنها تحش!
- تو اذيه تو شايفتنها بعيوني اذيه للي بياكلها الدود مغدفه فوق راسها ربطة وهيه ربطه حشو!.
- هو عليها واحت!]
العارفون وحدهم أداروا رؤوسهم ذات اليمين، وذات الشمال متعجبين ومحوقلين مستعيذين من الشيطان، ومن شر حاسد إذا حسد فيما كانت العجائز يمضغن التمر ويشربن القهوة المرة وهن يلكن حكاية زوينة، والصغير مبديات حرقة واضحة وأسفًا شديدا على ما حل بهما، وحين ران الصمت، وقضي أمر التمر والقهوة، وسكنت الأفواه هزت أكبرهن رأسها ألمًا وحسرة، وخاطبت الدائرة المكتملة من النسوة:
يممت بوليدها باتجاه مسقط في الأيام الأولى من ولادته على أرجح الأراء بعد أن: [قصت صراره ]، ودفنته في الهبوبية. الرابية المفتوحة الجهات للريح يأتيها هابًا من كل مكان، وللحب يأتيها رغدا بإذن ربها، وربما سيشكل هذا الرابط السري حبلا أكثر وثوقا بين الهبوبية، والطفل تاليا. الهبوبية بوح المصايف في أيام القيظ، والهبوبية التقاء الأحبة والأقران في رقاط الخلال والبسر، والهبوبية لذة التناهي في رطبة باسرة كأنها الشهد وأحلى، والهبوبية المكان والملجأ والعاصم من رطوبة مسقط حيث يزفر بحرها الهواء من منخاريه العظيمين كطائر ينبعث من الرماد!، والهبوبية هذا الوهج، وهذا الولوج إلى عوالم فاتنة آسرة حيث لا حد لمثيولوجيا الرسم في عقول صغيرة مدهشة، ومندهشة في آن!
(2)
في مصايف بدايات السبعينات والتي كانت فيها العائلة تزم نفسها إلى الرابية الخضراء بين نهايات مايو/أيار إلى بدايات سبتمبر/ أيلول كان الطفل أكثرهم فرحًا وتشوقا إلى تلك المرابع حيث عصافير الحياة تعبث بماء الفلج المنساب من الأعالي، وحيث ألفة الروح، والسكن، والرفاق الذين يتواردون في ذات الفترة من أماكن مختلفة كانوا يحلقون كفراشات زاهية لونتها طبيعة الرابية الخضراء بجمالها وفتنتها. يطيرون كفرح نزق من نخلة إلى نخلة، ومن قطعة إلى أخرى عابثين بسيدهم الماء المنساب - منذ الأزل/ منذ لا قِبَلَ لهم بمعرفته - في أقنية كأنه الغول الممتد من أم الفلج إلى قطع الزرع مغروسات ومعروشات.
(3)
قيظ هبوبية منتصف السبعينات: الزمن المتوحد في تيهه وخيلائه. الزمن المترامي بحره بلا سواحل في عيون الصغار المفتوحة إلى أقصى اتساعها دهشة. الزمن الذي لا يمكن كر بكرة الشريط إلى الوراء لاستعادته. الزمن الأجمل، والزمن الأحلى، والزمن الأحنى، والزمن الأملى في مشاهدات شرائح الحياة المتعاقبة، والتي ما فتأت تزداد رهبة وقسوة وغيله كل ما تقدم إعمار البشر وأعمارهم!
قيظٌ وهبته جنة المكان روحها وريحها وريحانها حيث الهبوبية نسجت اسمها من مهب النسيم الذي ينعم بنفحاته عليها من كل الجوانب، ونافلة عليه عيون الرضا الصغيرة التي تنظر بهناءة وفرح طفولي. كانت الهبوبية مفتوحة الصدر لقلوبنا الصغيرة ولقلوب الكبار أيضا كما هي مفتوحة للصَّبا من كل الجهات.
لا أدري أي انبعاث لسؤال المكان خطر في رأسي بعد كل هذا العمر الممتد من أم الفلج إلى فجيعة الذكرى: هل بإمكاننا أن نشتعل ونشعل الذكريات سؤالا ومراودات لا تنتهي عند أعتاب العمر وحسب بل تبقى خالدة مخلدة في برزخ لا تظل طريقها، ولا تنسى عند نهاية الرحلة؟ ليس مهما كثيرا أن يأتينا الجواب مطواعا وهينًا، أو أن يأتينا صفوانا صلدا لا ينفعه وابل المعرفة أو طل الاحتراق بل أن الجواب ليس مهما، أصلا،في هذا الجانب - إذا شئنا محض الرأي – سواء جاء أم لم يأتِ إنما الأهم – دائمًا – أنه أشعل فتيل الذكرى ليبدأ هذا الاحتراق اللذيذ والمؤلم في ذات الآن ليقف بنا على برزخ جميل: لا حزن فيه على ما فات، ولا خوف منه على ما يؤول!
(4)
في العقد الثامن من القرن الآفل كانت مراتع الصِّبا، ومرابع الخلان في الهبوبية لاتزال ترفد ساكنيها بالحب الأول، وبأ أخلاق القدامى والأسلاف ممن رحلوا أو لا زالوا، ظلت علاقتي في منتصف هذا العقد – تقريبا – بالهبوبية هي ذات العلاقة الطفولية – حد السذاجة – طفل كبير بشارب ونظارة طبية يجوب حواريها ويمتطي صهوة نخيلها "العوانات" ويرتاض في واديها وسهلها بعينيّ صغير لم يكبر! هل كنتُ نسيتُ أن أكبر؟ هل ظل الزمن خارج عقلي؟ هل كان القيظ يأتي ويمضي وعقلي يراه بذات العيون الراضية الكليلة عن كل عيب؟ وأي عيب يمكنني أن أراه في معشوق لا أسخط عليه ولا أتبرم؟!، وللحقيقة، وللأمانة، وللذكرى نافلة فوق ذلك فإن هذا العشق كان حريا به أن يضرب جذور نظارته في أرض قلبي ذاهبا به ومعه ومنه لا ينافسه في الحب أحد ولا يدحضه خصم أو ند.
(5)
أنىَّ ارتحلت، وأنىّ أقمتُ كانت: الهبوبية!
كان الزمان: الهبوبية!، وكان المكان: الهبوبية!
منذ أن هربت بي أمي في تلك السنين الشديدة: الفقيرة من عصيرها وحَبِّها وقثائها وبصلها، والمجدبة من اخضرارها وشحمها الثرية بآدمييها ولطفهم وتلطفهم، وحتى هذا العام المليء بشحمه وورمه الخالي من سماحة آدمييه وحُبِّهم وتبصرهم، ورغم تقلب الأزمنة أو تقلبي في الأمكنة فأنىّ وجهت قلبي: كانت الهبوبية!
أكثر من أربعين حولا وحبها لم يبارحني. كنتُ أحملها سِفرًا خالدا أطوقه برمانة الفؤاد، وأغلق عليه شغاف القلب!.
أما الزمان فلم يزد حبها إلاّ وهجًا: كلما كبر الطفل وشب وقارب فلك الشيوخ كبرتْ فيه الهبوبية، وزاد حبها: هي الخارجة من مسارات القرى والقبائل، والداخلة في أفلاك العشق السرمدي المقترب من الأعالي فهكذا حبٌّ لا يمتطي مصالح، ولا يبتغى أجرا هو الحبُّ المعصوم عن التدنيس والزيغ والرياء يكبر قليلا قليلا لكنه كالأشجار تضرب جذورها بعيدا في الأعماق ليغدو عملاقا، ويعيش واقفا حتى وهو يموت!.
(6)
منذ العام 1965م وحتى 2010م عُمرٌ مكللٌ بانتصارات وهمية، وهزائم مُرة. عُمرٌ - ربما يكون – أزهرَ، وأثمرَ قطافه مذاق الصبر لفاكهة الغد المشتهى. هذا الغد الذي لا يجب أن أحمل همه أبدا، وأحلم به ورديا كأي طفل في هذا الكون. الغد المباغت للرغبة وللرهبة، والمسفر عن وجهه ضاحكا مستبشرا، أو ترهقه القترة. الغد الذي نعمل معاول فكرنا في تقليبه، وننشب أظافر يأسنا في تخيل ماهيته بدون أن نترك لأنفسنا فرصة التجلي ليومنا الحاضر حتى إذا ما مضى هذا الأخير أصبح أمسا منسيا لم نتمتع به كيومنا وغدنا اللذين فرطنا فيهما كذلك لكنني اليوم قررت أن لا أفكر في الغد بهذا السوء والريبة والتوجس. فكرتُ – فقط – في أن أنبش الأمس لأصالح به الغد، وأرتق به عباءة اليوم. اليوم الذي ينبعث فيه سؤال المنازل الأولى للحبيب الأول حيث منازله أعلى المنازل، ولن ولم تزل بيد أن عاملين زادا في ذلك الحب أواره أولهما: زوينة بنت عبدالله بن سالم الحميدي، وثانيهما: هذا الأفق الممتد المفتوح لاقانيم الهبوبية كمسطح أخضر، وكرابية عالية، وكواد خفيض، وسهل مكتظ باليمام والطيبة.
فمنذ ذاكرة الطفل الأولى – التي لا تشيب! – ، وحتى نهاية العقد التاسع من القرن الماضي – تقريبا - عرفتُ الهبوبية فضاءً لا متناهيا وممتدا من طيف الوادي إلى طيف الجبل. فضاء واسعا لشغف الطفل وشغب الصغير لا يحده حد، ولا يطوق بالحديد، وهو شأنها كذلك داخل مسطحها الأخضر حيث تتداخل الأراضي والنخيل والأشجار الطويلة والزاحفة كتداخل الأهالي والناس لا يكاد – لفرط التداخل – تفرق بين جلبة هذا وجلبة ذاك، أو قطعة هذا وقطعة ذاك، أو أشجار هذا وأشجار ذاك مما كان لأرجل الصغار – كما لعقولهم – حرية الانطلاق بدون قيد أوحد بل أنني في السنوات الأولى من نهاية السبعينات من القرن الماضي كنتُ أستغرب من أبي كيف يستطيع التمييز بين ما له وما لغيره!
كان ثمة تناغم يموسق حركة أرجل الصغار المتحررة من رزانة الكبار ماضية في نزقها وزعيقها بسرعة متمادية في ركضها حد الطيران من جهة، و ما بين الحارة حيث البيوت المرصوصة إلى جانب بعضها بعضا وبين أراضي أموال النخيل وأشجار الحمضيات المتعانقة والمتآلفة حد التوحد من جهة أخرى. كنا ونحن صغارًا مسكونين بالركض في كل وقت وآن! كل شيء يخضع لهذه اللعبة المستمرة حيث وفرت صدور الكبار المتسامحة لنا مساحة أكبر وأكثر فيما تكفل انفتاح الأراضي الزراعية الخفيضة أدنى الحارة بالاتساع الأكثر رحابة والأكبر تساميا لحركاتنا المتسارعة في تصاعد موسيقاها بين حفيف النخل وأصوات الطبيعة البكر للطيور والعصافير المسافرة أو المقيمة ممتزجة بالصراخ والهرج الناشئ عن انبعاث جنون الصغار الراكضين فرادى وجماعات على أرض حملت نقاء قلوبهم وشقاوة أفعالهم وتحاملت على ألعابهم التي تخطت حدود العقلي والبريء بعض الأحيان!.
أما اليوم فلم تضق صدور الرجال وحسب بل ضاقت صدور الأراضي عن بعضها بعضا فلا ترى إلا قطعا ترسف في قطع الحديد، أو تزنرها الأسلاك حتى أنك لتمشى مخالفًا حركتك بين جداري الساقية تحاذر على نفسك من أن يقذفك حديد هذه القطعة إلى أشواك حديد القطعة الأخرى! كل ذلك التحول الحديدي جرى سريعا بدون أن يلحظ أحد أو يحرك ساكنا، والأنكى أنه حدث متأخرًا وفي هذا الوقت حيث انهارت جدرانا عظيمة بين الدول كالجدار بين الألمانيتين مثلا فيما تصاعدت الحجب والجدر في تلك الأراضي، ولذا كان لزاما على تلك الألعاب المعتمدة على الركض أن تختفي كذلك فليس من المؤمل أو لنقل بتفاؤل ما ليس من السهل أن تصادف منظر الصبية وهم يهبون أرواحهم للمطلق، وأرجلهم للريح!
آه أيتها البلدة الطيبة التي وهبت حشاشة داخلها المكتظ بالنزف والمخاض، وأسلمت نفسها راضية مطمئنة لأحبتها الصغار! كم علينا أن نقف في حضرتك صامتين تبجيلا واحتراما أيتها الأم العظيمة التي تمد أوردتنا بدفء محبتها، وتحيط أرواحنا بسقيا روحها لينبت فينا ريحان جنتها وجناها!
(7)
أما زوينة بنت عبدالله بن سالم الحميدي – رحمها الله وغفر لها - فتلك قصةٌ أخرى.......
|