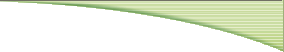|
قسم فضاءٌ حر
(مقال) الخائفون في الأرض |
|---|
الخائفون في الأرض
(مقال)
صديقي العزيز:في البدء – سيقولون لك ذلك حتما – كانت الكلمة!
سأقول لك - يا صديقي - في البدء كان الخوف!
كان هذا الآدمي الذي هبط من عليائه/ جنته يضع أول خطوة على البسيطة ممتزجة بالوحشة والرعب. ضاربا في مظنة الوحدة ونصب العذاب الأبدي يتلفت يمنة ويسرة في صحراء شقائه باحثا عن ألفة فلا يجد إلا سراب الإجابات وفضاء الامتداد متراكبا بعضه فوق بعض كأنه الظلمات من فوقه ظلمات، ومن صلبه تناسل الخوف إلى ذريته محمولا في أرحام النساء وأصلاب الرجال من أزل الأزل إلى أبد الأبد، ورغم حصوله على الرفقة والوليف – تاليا - بيد أن الخوف كانتا قد تسرطنت خلاياه المتوالدة بشهية دبقة في نسل هذا الكائن الجميل ولم يكن بالإمكان استئصالها، وبهذا ترى – صديقي – أن الخوف ولد كبيرًا!!.
ها أنت تعرف السبب الذي أخبرتك عنه في مهاتفتنا الأخيرة لكن كلمة الخوف وحدها كلمة عامة وممتدة وفضفاضة وتحتاج إلى تفاصيل. ربما فكرنا/ نفكر في الهروب من الخوف – أقله مرة في العمر. حسنٌ إذن، السبيل الأمثل للهروب من الخوف مؤقتا- وبمحض اعتقاد شخصي ليس في تهيبه بل تمثله عيانا ليستوي الغريم والغارم في هذا الغرم الواقع في حبائل غرام الخوف!.
لطالما تساءلت – شخصيا – كيف تخطى الإنسان الأول خوفه؟ وهل حقا فعل ذلك؟ أم أنه لم يستطع تجاوزه مطلقا؟ فكما سطرت لك سابقا أن الخوف ولد كبيرا ولكنه لم يصغر أبدا - (كما هو الحال مع المصائب والفواجع مثلا إذ تبدأ كبيرة ثم يتكفل الزمن بتقزيمها وتفتيتها في نوبات متقاربة أو متباعدة من النسيان والتناسي هذا إذا افترضنا أن الخوف كارثي حقا!) - بل ظل يكبر ويكبر من عصر لعصر ومن طريف الإنسان وتالده حتى وصل إلى هذا الإنسان الأخير المحمل برحلة التيه المخيفة، والحامل بذور تناسله وتواصله الخائف والمخيف لخلفه كما يحمل صفاته الوراثية من أسلافه هنا نلمح فكرة الألمعي إذ يلتفت إلى ذاكرته التي ربما غفل عنها هنيهة (هنا تذكرتُ أن الدهر خوانُ)، والحقيقة أن الدهر ذاته جزء من متاهة الخوف التي رسمت للإحاطة برحلة هذا الإنسان الأرضية ربما يمكن اعتمادها بشكل أو بآخر على أنها خلفية صالحة لسير الأحداث، وصيرورتها.
صديقي العزيز لطالما طاردتني وحشية السؤال وجنونه منذ بدايات الوعي – الذي ما زلت على عتبته حتى حينه – لكنه في السنوات الأخيرة – ورغم أنه ترسخ كهاجس في محطة أو محطات ما من هذا العمر! – تحول إلى سمير عزيز أحمله في حلي وترحالي كما أحمل سِفْرَ أبي الطيب ولكي نمسك بجذوة السؤال التي لا تزال وهجا واصطلاءًا: هل تخطى الإنسان الأول خوفه؟ وهل حقا فعل ذلك؟ أم أنه لم يستطع تجاوزه مطلقا؟ ربما تعلمنا – أقول ربما وهذا أيضا محض رأي يُرد ويُقبل - من أسلافنا القدامى فكرة الهروب إلى الأمام فدافع الخوف من الطبيعة والوحوش والبشر بعضهم بعضا أوردهم فكرة التأليه. تأليه الطبيعة ذاتها وظواهرها العنيفة والمخيفة والمحبة والجميلة على حد سواء فإله للشر، وإله للكره وإله للحب وإله للجمال، وتأليه البشر بعضهم بعضا كذلك فالسواد والسيد نتاج هذا الفهم المتخوف والمخيف بدءًا بتسلط إنسان الغاب عبر القوة الهمجية، ومرورا بالعقد الاجتماعي ونسبية منظرية الثلاثة في تعاطي هذه النظرية واتفاقهم – تقريبا - على مسألة التنازل بمقابل تكريس لمبدأ الحماية الذي هو بلا شك نتاج مسألة الخوف التي نحن بصددها حيث يتنازل السواد لسيدهم، وحتى هذا التأليه البشع للمادة والمصلحة بشكلها الغوغائي المذل لقيمة الإنسان، وقد امتزج كل ذلك بجاهلية الإنسان وغفلته حيث كلُّ شيءٍ مسبب له في نظره ومعلق على مشجب الزمن والدهر ليسدر هذا الكائن في غفلته وتيهه ونسيانه. لكن، ولننتبه هنا، هل يمكن تعليق كل ذلك على فكرتي الجهل والغفلة!؟، وكما ترى فإن السؤال لا يوصل إلى نهاية النفق حيث الإجابة تنتظر على الجانب الآخر من النور بل على العكس تماما فإن الأسئلة تتوالد وتتكاثر وكل سؤال من هذا القبيل يتحول إلى متوالية من الأسئلة التي تدور وتدور في حلقات تتماس مع النار والنور!!.
من الضفة الأخرى إذا سلمنا لفكرتي الجهل والغفلة بذلك فيما سلف فكيف يمكن تقبلهما في هذا العصر حيث العلم والعولمة، وحيث الدقة والترصد، وحيث هذا الانفجار المعرفي الذي تفجرت فيه طاقة الآدمي، وبمعنى أكثر وضوحا كيف يمكن تقبل المعرفة الخائفة؟ هل يمكن تقبلها كذالك من جوانب مسببة ومعلقة على مشاجب تبريرية من قبيل لكل عصر جُهّالَه لندخل في محطات النسبية من جديد؟!.
الحقيقة التي أزعم – يا صديقي – أن الإنسان طور صناعة رهيبة للخوف تقوم على آلات مرعبة ومهيبة طور فيها كل إنسان صناعته بحسب عصره، ولأن عصرنا هو الحلقة الأخيرة – حتى الآن - في ترس تلك الآلة الفظيعة فإنه جاء كذلك شبه مكتمل النشأة والتقويم من مثالب آلات صناعة الرعب والخوف السابقة فعلى مدى سنين عديدة طور الإنسان وجدد في صناعته تلك حتى استوت على أرجلها واقفة ظاهرة شاهرة لا لبس فيها ولا مراء، وبهذا ترى أن ثمة اختلافا نوعيا في مسألة الخوف هذه فلئن كانت في ما مضى فطرية وبديهية، وتُمارَس بشكل بدائي وهاوٍ فإنها تحولت في هذا العصر إلى صناعة احترافية، وكأنها صولجان ضخم في يد القوة العظيمة! صولجان تلوح به متى شاءت وأنّى شاءت اعتمادا – ويا للمفارقة حقا! – على خوف الآخر الفطري والوراثي.
لا تذهب أخيلتك شططا فليست صناعة الخوف احتكارا وقفيا في يد الدول وحسب بل هي فوق ذلك ما انفكت قبضة حديدية يلوح بها الفرد تجاه الفرد فيمكن للأب والأم مثلا أن يكونا صولجان رعب على أبنائهما من خلال الفروضات والممارسات القمعية والتعسفية، وإذا ما اتبعنا مسألة القياس تلك في فهم تلك الآلية لفرض الهيبة والاحترام فيمكن لنا بلا شك تلمس فكرة ممارسات الدول – كل الدول بلا استثناء – لمساءلة فرض هيبتها/ خوفها في قلوب مواطنيها من خلال طرفي المعادلة الترغيب والترهيب وإدارتهما - في الغالب - من خلال أجهزة ناعمة الملمس نارية التسلط ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب.
حسنٌ إذن تريديني أن أشارك! سأقول لك لقد أطربني مديح ظلك العالي جدا بل أرقص روحي فرحا (ربما الذبيح يرقص ألما كما قال طيب الذكر) خصوصا تلك الكلمة الذهبية «مثقف نوعي» وأنا أقعد ملأت رئتيّ بكمية أكبر من الهواء واستويت منتشيا على مقود السيارة لكن ليس هذا كل ما أريد قوله حقا كنت أريد أن أقول لك بملء إرادتي الحرة النزيهة: أنني رجل خائف!!!.
رجلٌ خائفٌ مثلي تماما مثل عُرض القوم، وخاصتهم: خائفون، ومخيفون! ففي عصرنا هذا متمثلا في ما مضى من العقد الأول لهذا القرن، وأواخر القرن الذي لفظه برزت بشكل مقيت مذل ومهيمن الأداة الاقتصادية لإدارة الخوف فالعيون مشرئبة إلى خراطيم هذا الوحش الذي يتوزع في الفضاء، وإذا شئت بعض التبسيط يمكنني التمثل بخوف التاجر على سلعه من البوار ومن إعراض المشتري عنها، وبالمقابل خوف المشتري من التاجر وجشعه، خوف السياسي من المواطنين، وخوف المواطن من كل ما يتعلق بالسياسي، بل ان الخوف مؤخرا وتحديدا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر دخل حقبة تفصيل التفصيل فالكل خائف من وهمه وطواحين هوائه فبغتة وعلى حين هجمة أصبح الكل دون كيخوت يحارب عملقة الخوف المتنامية في الأذهان كما هي مترسخة في الواقع فالدول خائفة كما الفرد خائف على نفسه، ومن نفسه، ولنفسه، ومن غيره: الطبقة الدنيا – والتي تزيد كلما أوغلنا في التقدم المعرفي والازدهار الاقتصادي – خائفة من الطبقة العليا والتي هي بدورها عدد محدود يمتلك النسب الأعلى من الثروات، والمتعلم خائف من الجاهل والعكس بالعكس بل أنني أكاد أتلمس الخوف من بين محاجر البسطاء على رزقهم، وعيون علية القوم على مناصبهم، وما بينهما فتنة من بحار الخوف تنهش هذا الإنسان لتحيله – إن لم يترصدها – إلى هباء ورماد تذروه الرياح!.
سياق الخوف بعد الحادي عشر من سبتمبر أدخل العالم بمنظماته، ودوله، وأفراده إلى حلقة مفزعة من الخوف الجديد حتى أن هذا الخوف طال الديني، والرب، والرحمة وهي الركائز الأخيرة التي يتشبث بها هذا الإنسان ليمد يده في لجج الظلام والظلم والغرق لتنتشله من وهنه ووهمه وهمه لكنها أُصيبت في صميم مقتل لأجل أهداف مصلحية ووضيعة لقولبة المفاهيم وإحداث شروخات لا تلتئم في الفكر الإنساني بهدف تكريس الدول والأنظمة الغاصبة على أنها ديمقراطية وحرة وشريفة ونزيهة مقابل إزاحة مفاهيم الكفاح بوصمها بالإرهابي والانتحاري والغوغائي من خلال إبراز المتطرف والمغالي والحدي، والذي بدوره سهل هذه المهمة إما مدفوعا من عقيدة متطرفة، أو من خلال أهداف برجماتية ليبرز هذا الخوف ماثلا للعيان ليل نهار، ولترى – يا صديقي – أن هذا الرج الأمني يؤتي أكله بشكل مبهر في تقبل مفاهيم وأفكار جديدة كالضربات الاستباقية، وإما معي أو ضدي، ومحاربة الإرهاب، وجلب الديمقراطية!، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم.
صديقي الطيب: بهذا ترى أنني من جنس اشتقاق هذا الإنسان وهذا الخوف، ولست عن ذلك ببعيد فهذا الخوف الذي بداخلي تقلب بي من عتبات الوعي إلى هذا الصولجان المرعب للخوف الذي يُلوح به في وجوهنا ذات اليمين وذات الشمال. ربما كان خوف عتبة البدايات جميلا وشريفا وإيجابيا. كان يدفع باتجاه نزف السؤال للبحث عن إجابة. كان مهرا جامحا يصهل في البرية. كان مدى لا يدرك، وأفقا صعب المنال يدفع باتجاه الشمس البعيدة أما خوف خريف النهايات – كما أحب أن اسميه - فهو خوف قبيح وضيع وسلبي بكل ما تعنيه الكلمة من سلبية. هو خوف آسن راكد لا ظهرٌ- فيه - ولا غببُ!! هو خوف لا ينتمي إلى القلق حيث الريح باعثة من تحت أكمتها غبار الطلع لعرجون السؤال، ولكنه غباري الطالع يضيع مسالك الدرب، ويشل بصيرة السؤال حيث العمه والعمى مقود العربة الأمامية التي تحتنك العربات برسنها المنتن!.
فكيف يمكن لإنسان خائف أن يقول ويتقول ويحرك الرغبة والحب في الجموع؟؟! كيف يمكن لمثقف نوعي أن يحدث فرقا وهو خائف يترقب!!؟.
أعرف أن الخدعة لن تنطلي عليك، وأن كل ذلك ليس سوى أعذار لتبرير عدم اشتراكي خصوصا وأنك خَبِرْتَني في مواضيع مماثلة وأمور أخرى ولمست سلبيتي وردي غير المتجاوب مع طلباتك لكن ليس هكذا هو الوضع أبدا فأنا أؤكد لك أنني مثقفٌ – إذا كنتُ كذلك حقا - خائف!
خائفٌ من هذا الدمار والقبح الذي يحوطنا جميعا. خائف من هذه الديمقراطية التي تفرض علينا من فوق حاملات الطائرات. خائف من هذا الدين الذي يسلع لنا باسم الرب (علما بأنني أحب الله كثيرًا، وأرجو أنه يحبني لأنه كرّمني منذ البدايات وعلمني الأسماء كلها). خائف من العادات والتقاليد التي تزنرني بنارها وتخلفها. خائف من وسائل القمع الحديدية ذات الملمس المخملي أن تتخطفني. خائف من هذه الدماء، وهذه الأوبئة، وهذه الأرض التي تتناقص أطرافها، وهذا الإنسان الذي يأكل بعضه بعضا.
خائفٌ من تفاصيلي اليومية الصغيرة والمملة والرتيبة – والتي أزعم - أنها عميقة وعقيمة في آن. خائفٌ من زميلي في العمل لكي لا يطير بالترقية التي هي حقي. خائفٌ من مسؤولي الوظيفي أن يظلمني. خائفٌ من مدارس الأبناء التي أرهقتني بمطالبها ومطاليبها. خائفٌ على أبنائي من أداء أساتذة المدارس الحكومية. خائفٌ من خلو رصيدي هذا الشهر مما يدفعني للاستدانة أكثر لأسدد أجر الأساتذة العرب الخاصين بأبنائي. خائف من قسط البنك، وخائف من وكالة السيارة، وخائف من غول الفواتير، وخائفٌ...
لعلني أكون خائفا على بعضي من بعضي!، ولكنني على يقين تام بأنني لا أصلح لهيئة الأمر بالقراءة، والنهي عن الجهل في هذا الزمان، وهذا المكان، وهذا الظرف فالإنسان الخائف – مثلي – لا يصلح لشيءٍ أبدا.
على أنه - وللامانة أيضا - فإن أجمل وأفضل ما ينتجه الخوف هو قدرته العالية على تجلية الكلمة الحرة والنزيهة وجلائها بين ظهراني القوم تماما كما تظهر قدرات الإنسان الحقيقية وتكاتفه ابان الحروب والكوارث الطبيعية أو الإنسانية حتى ولو ظن بعض عملاء الخوف وأساطينه – لبعض الوقت - أنهم نجحوا في كبح جماح هذا اليراع النازف بالحرية والجمال فإنهم سيكتشفون زيف ظنونهم وضحالة ترتيباتهم فالكلمة مسؤولية لا يمكن بسهولة التملص منها ومواراتها الثرى بل هي سنام الأمر الذي يبزغ عاليا كالثريا جميلة ورشيقة وعالية في الطرف الأغر من السماء!
صديقي العزيز:
في النهاية – ربما ستقتنع – أنه الخوف!
سأقول لك - يا صديقي – أن الكلمة تقع بين: فارزتي خوف عظيمتين. تقع بين: خوف، وخوف! نعم نعم تماما كما ينبغي للصفة الحميدة/الفضيلة أن تقع بين رذيلتين!
|
|
|
| | |